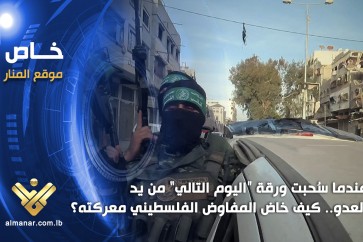ما هو يوم اللاجئ العالمي؟ تسأل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على صفحتها. بعد السؤال تأتي الإجابة، بلسان المفوضية نفسها، “هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويصادف في 20 حزيران/يونيو من كل عام”، ليحدد بعدها الهدف من هذا اليوم بالقول إنه ” مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم”.
فليحتفي اللاجئون إذاً بيومهم العظيم وبشجاعتهم في مواجهة الحروب والاضطهاد، وليستريحوا ايضاً لأن هناك من “يتفهم محنتهم ويعترف بها”، هللويا!
لسنا نتهكم هنا. ولسنا ضد تخصيص “يوم للاجئين”، لكن هذه “الرومانسية الأممية”، التي ينضح بها التعريف بهذا اليوم وبأهدافه، تبدو فضفاضة حد الاستفزاز في ما يتعلق بتوصيف أحد أكبر المآسي التي تنتجها الحروب والأزمات والصراعات المستمرة حول العالم.
في السياق، نسأل: ما هي نسبة اللاجئين الذين استطاعوا حقاً تجاوز محنتهم والحصول على فرصة حقيقية لحياة أفضل والاندماج فعلياً في البلاد التي نزحوا إليها؟ سرعان ما يأخذنا هذا السؤال إلى اشكاليات أعمق حول معايير كثيرة ومتشعبة كهوية اللاجئ، ماهية الصراع الذي أدّى إلى رحيله عن وطنه، إضافة إلى طبيعة وظروف الدولة التي لجأ إليها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
هنا وسط طرح هذه الاشكاليات وتشريحها، لا بد أن تحضر فلسطين وابناؤها، لأسباب عديدة. نعم ليس الفلسطينيون وحدهم من هجّروا قسراً من أرضهم إلى غير رجعة. ليسوا وحدهم من ذاقوا مرارة الشتات. لكنهم وحدهم، في العصر الحديث، من سلبوا الهوية بما تعنيه من انتماء وثقافة وجغرافيا وتاريخ، حتى أنهم إن بحثوا وابناءهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم و و و عن فلسطينهم على خريطة العالم لما وجدوها.
نعيد صوغ السؤال وطرحه على مفوضية اللاجئين: كيف لكم في هذا اليوم أن تتفهموا محنة هؤلاء الممتدة من عام 1948 (بداية نكبتهم)؟ ما هي طقوس الاعتراف بعزيمتهم؟
ستة ملايين وأربعمئة ألف نازح، وأكثر بكثير (يقتصر هذا الرقم على المسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولا يشمل أعداد النازحين داخل فلسطين المحتلة)، تنهش ذاكرتهم وأرواحهم يومياً: مع كل تمدد استيطاني، مع كل اعتقال وقتل يمارسه جيش الاحتلال، مع كل تدمير لمنزل من منازل أبناء وطنهم، مع كل عدوان على قطاع غزة، مع كل أسير تقتل أحلامه بالحرية داخل السجون، مع كل خيانة واستسلام، مع كل تطبيع، مع كل سرقة لتراثهم الجميل، مع كل همجية تمارس بحق زيتونهم، مع ومع ومع.
مع كل هذا، وفي هذا اليوم العالمي الذي تحتفون به، (استوقفتني بالمناسبة ايضاً عبارة “يحتفل العالم” في التعريف الرسمي لهذا اليوم)، في هذا اليوم أؤكد لكم أن هذه الرومانسية الكاذبة لا تعني شيئاً لمن سيطر الاحتلال، المعترف به عالمياً ومن قبل المنظمة التي أنتم جزءٌ منها، على أكثر من 85% من المساحة الكلية التاريخية لوطنهم.
لقد بلغ يومكم هذا 23 عاماً (أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000). إلى أعوام كثيرة مقبلة، ليكبر ويكبر حتى يتسع لكل أحلام اللاجئين ويحقق هدفه السامي بتمكينهم بعيداً عن أوطانهم، وهنا اشكالية جديدة. فخطط ومشاريع “تمكينهم”، بالمناسبة وكما تعلمون جيداً كانت ولا تزال في كثير من الأحيان خاضعة في نوعها وكمّها لنفس المعايير التي ذكرناها في البداية أي هوية اللاجئ وطبيعة وأولوية الصراع الذي سبب نزوحه، أولويته وفقاً للمعايير السياسية ومصالح الدول الكبرى المتغيرة بدورها بين مرحلة وأخرى.
هل تعلمون ما هو الأفضل للاجئين؟ الفلسطينيين أو حتى السوريين بالمناسبة الذين مورست بحقهم الرومانسية نفسها لأعوام لأنهم “طلاب حرية وجب احتضانهم حتى سقوط الديكتاتورية في وطنهم”، ثم باتوا عبئاً لأن حربهم طالت دون جدوى، ورست جثثهم على شواطئ النزوح، هل تعلمون؟
الأفضل أن تصمتوا!
المصدر: موقع المنار