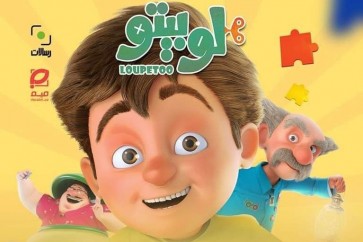لعلّ الدكتور الناقد علي زيتون يوفّر عليّ الكثير من الأوراق البحثيّة حين يقول في مقدمته لرواية “ها هو اليتم في عين الله” :”لا تحمل كتابة السيرة النبويّة الشريفة الهمّ الرساليّ وحده. يترافق هذا الهمّ مع همّ أخر هو الهمّ الأدبي. ذلك أنّ السيرة الشريفة ليست سيرة أيّ إنسان عادي، تتطلب من الأهمية والإستعداد والإمكانات العلميّة والأدبيّة ما لا تتطلبه سيرة أخرى”.

من هنا تنشأ علاقة وطيدة بين الخطاب التاريخي والخطاب الروائي، حين تنشأ الشراكة في الإثارة المعرفية. وهذا ما يقودنا إلى فهم العنصر الشريك خطاباً ووظيفة، قبل خضوعه لآليات التشغيل الجديد ضمن سياق الإنتاجية الروائية. ويؤدي تالياً إلى بناء مسلك خاص بالقراءة يجعلها ذات صلة وثيقة بـ”البعد النفعي” من دون أن يعني ذلك التضحية بالبعد الجمالي الذي هو شرط طبيعي لكل قراءة أدبية. فانحياز الرواية إلى التاريخ، واختياره مادة للشراكة الفنية، تحريض طبيعي للقراءة النقدية على استنطاق الوظائف والدلالات أكثر من الأبعاد الأخرى. وإنّ النزوع الدلالي أصيل في الإنتاج الروائي أكثر من غيره، ولقد تنبّه جورج لوكاش إلى ذلك حين حدّد بشكل عام محتوى الرواية بقوله :”الطريق الذي يقود الإنسان إلى التعرّف على نفسه”. ونستطيع بقليل من النحت القول : إنّ المحتوى الدال في الرواية التاريخية، هو الطريق الأمثل ليتعرف المجتمع العربي إلى نفسه .
فرواية “ها هو اليتيم في عين الله” تنزع إلى استنطاق الدلالات المعرفية، سواء تلك التي كانت سائدة في عهد النبيّ محمّد (ص)، أو التي تتمحور معانيها في استقراء الحاضر المشوب بالأزمات الفكرية والثقافية ذات المنبع الدّيني من مصدريه القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة. هذه الرواية تغوص في أعماق التاريخ الدّيني في شبه الجزيرة العربية، وتحرص حرصاً شديداً على أن تتلبّس به، إذ يسترجع نصها الأدبي أسئلة الواقعي والمحتمل، الروائي والتاريخي؛ المؤتلف والمختلف، غير أنها ستختار أن تنزاح عن التاريخ عامودياً من خلال عملية حفر دقيقة في وقائعها وإشباعها بالتفاصيل، لن تستلهم الشرط الهزلي واللعبي – وهي من عناصر الفن الأدبي، بل جعلت سياقها مفعماً بروح التاريخ سياقياً، أي أنها تعتمد المسار الجاد وإن لم يكن كاملاً.
هي رواية تقوم على مواجهة التاريخ الحديث مع كثافة الحجب وتلبّسه بالآني، تجعل القراءة منقوصة بالتصرّم اللانهائي، ولأن تقدير المكان الذي يبغي التوقف فيه داخل هذه السيولة الأنطولوجية غير مأمونة النتائج، فإن الرواية تقترح العودة إلى الجذور لتلمّس الصراع الحضاري طرياً، في راهنيته السابقة- الماضي، وقد صار الإمساك بها والنحت عليها ممكناً. والرواية فعلت ذلك بطريقتها الخاصة، فغدت محفلاً سردياً لأنواع من التلفظ جعلت النص رواية تستطيع أن تقرأها وتسمعها وتراها وتشمّها.. تملاْ عليك الحواس والمطارق، وصرير الأبواب وأزيز المزاليج، وأناة الحفر على الخشب. إنها حكاية محمد النبيّ الذي اختتمت به رسالة السماء تنشق من قلب انهيار جمعي لثقافة العرب الجاهلية .. إنها صور جَلَبة حياة تختنق تحت الأرض، وهي في الآن نفسه جلبة لحياة أخرى كانت ترتفع فوق الأرض مع بزوغ الولادة المباركة لأعظم شخصية في التاريخ الرساليّ الإلهي.
منذ العنوان “ها هو اليتيم في عين الله”، يستحضر ذهن المتلقي أفقاً مصاحباً للخطاب الديني، ويرافقه في الرواية منظوارن لشخصية النبي محمد (ص)، الأول وفاق منظور الشخصية التاريخية الواقعية، والثاني وفاق الشخصية المقدسة التي رافقتها العناية الإلهية منذ لحظة الولادة. هذان المنظوران اللذان تمثّل كلاهما في الرواية ارتبطا بخطاب سردي تاريخي مشوب بتفكيك عناصر البنية الثقافية للبيئة العربية في تلك الحقبة المزامنة. وهذا ما ملّكه قدرة كبيرة على إنتاج خطاب جمالي أدبي منح الرواية مرافعة تثاقفية أثبتت في كل مناحي السرد بأن ما تحكيه ليس خيالا ولكنّه حقيقة في إطار مغاير من الرؤية التقليدية لسيرة النبي الأكرم، رؤية تفجّر معها صنوف التأويل الديني لفقهاء السيرة بين معايشات لا تغادر جدران الحبر المكتوبة به وبين رحلة أدبية تطوف الأذهان وتخرق الألباب وتفتح أبواب القراءات المحرّمة وتأويلاتها على مصاريعها .. فالقطيعة المزعومة بين الجاهلية والإسلام لن تكون في صالح الإسلام، والجهل بمعتقدات ذلك العصر وموروثاته وسلوكاته، هي في جوهرها جهل بالإسلام. كما يُشير محمد أركون.
مع هذا السرد الروائي في “ها هو اليتيم في عين الله”، يبدو التاريخ في سياق مرويات بالغة التداخل؛ وذلك حين يتعدد صوت الرواة فيها إذ تتقاطعُ فيها الأفكار مع الشخصيّات، وهو قابلٌ للتجيير والقراءات المختلفة. إذ إنّ حساسيّة التاريخ الديني تحديداً هي في أنّهُ يمسُّ عملية صناعة التفكير بشكلٍ مُباشر؛ حيث تقولِبُ الجماعات الملتزمة رؤيتها ومبادئها وفاق أشخاص التاريخ؛ فتقبل أو تنفي أو تعالج النصوص الدّينية كافة وفاق أشخاص رُواتها ومُمارسيها. فتعدد الرواة وأصواتها في هذه الرواية مشغول بسردية الصوت الواحد الموزّع على شخصيات مختلفة تروي الحدث من وجهة نظرها وتعبيرها الخاص.
وجهة نظر جديدة بدأت تشقّ طريقها إلى عالم الرواية العالمية، حين بوشر الشغل عليها منذ سنوات طوال، قد تكون بدأت مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حين جرى بقرار واعٍ من القيادة العليا في أنّه آن أوان كتابة صوتنا الخاص في الأدب العالمي, نقدّم تاريخنا فنياً بصور حديثة لتعود الحضارة الإسلامية تشارك مجددا في ركب الحضارة العالمية، وعجن ذلك كله في وعائه اللغوي في فن الإنشاء، والكتابة.
الترجمة الخلاّقة :
غير أن عائق الترجمة يبقى الأصل في عملية المشاركة هذه، سواء من أهل اللغة الأصلية أو من المترجمين أنفسهم. ووصل إلى أيدينا نصوص أدبية عديدة فارسية مترجمة، غير أنها لا ترقى إلى المستوى الأدبي المطلوب. ولكن لنا أن نتفاءل مع صدور رواية “ها هو اليتيم في عين الله”. إذ تنجح هذه الرواية المترجمة، في أن تكون انفتاحاً جديداً للغاية يضرب في عمقه إحساسا عميقاً لدى القارئ بحيثيات السيرة النبويّة الشريفة، والمقتصرة في هذه الرواية على مرحلة الطفولة حتى لحظة البعثة الأولى، يدفعه إلى تلقف واعِ كلّي وجزئي لمعطيات الأحداث التي سبقت الولادة المباركة واللاحقة لها وما بعدها. وتصبح بحقّ أن تتصف بتلك الصفات التي عدّدها الناقد الروسي ميخائيل باختين بأنّ الرواية من أكثر الأشكال التعبيرية انفتاحاً على الأساليب واللغات والأصوات والأشكال. ويشمل الانفتاح، ذاكرة الأشكال القديمة، وأفق الذاكرة المستقبلي. لذا، عُرفت الرواية بالشكل المُتسامح مع باقي الأشكال، لكونها تسمح باحتواء مختلف الخطابات والتعبيرات، لكن ضمن شرط التمثّل السياقي الروائي، الذي يجعل الرواية تتشرَب هذه الأشكال، وتعمل على تحويلها، حتى تصبح مكّوناً روائياً، ولكنها تظل حاضنة لتاريخ ذاكرتها النصية. وهذا ما ينطبق تماماً على هذه الرواية.
في هذا السياق، تأتي رواية “ها هو اليتم في عين الله”، مفارقة إلى أبعد الحدود الأدبية لأي رواية أخرى، سواء كتبت بلغتها الأصلية، أم أنها رواية مترجمة. ويمكن الاعتراف من دون مواربة بأن هذه الرواية رواية عربية أصيلة، وما صفة “رواية مترجمة” (من الفارسية إلى العربية) إلا لتضفي عليها سحراً آثراً يخلق لمكتبة الأدب العربي مفصلاً تاريخياً ترتسم معه معالم أساسية لصنف جديد من الرواية الأدبية وهي الرواية التاريخية الدّينية. كما يمكن أن يدرجها بعضهم في خانة الرواية الجديدة التراثية التاريخية، وهي صنف من الرواية العربية دأب على الحفر في الموروث السردي عن أحداث تاريخية وأشكال تعبيرية، تسمح بتنضيد الشكل الروائي وإغنائه جمالياً، من دون التضحية بأطروحته، وهي موئل دلالته أكثر من أي فن أخر .
وهنا قد يلتفت القارئ إلى مفارقة جديدة في سياق ما أقوله حول الترجمة الأدبية، فأدخل إلى ما يتحدث عنه عادة في هذا المورد حين تتهم الترجمة الأدبية بالخيانة. إذ غالباً ما تنعت الترجمة عامة، والأدبية تحديداً، ظلما بخيانة النص المترجم، بمعنى من المعاني. ومردّ ذلك إلى عدم التمييز بين الترجمة العلمية والأدبية من ناحية، ولسوء فهم حقيقة ماهية الترجمة الأدبية من ناحية ثانية، لتختزل المسألة غالباً في مجرد نقل واستنساخ حرفيين للنص المترجم، بغض النظر عن طبيعته ونوعيته. رواية “ها هو اليتم في عين الله”، تنقلنا إلى مقولة أخرى تثبت معها أن ترجمة النص الأدبي هو عملية إعادة إبداع للنص الأدبي المترجم في غير لغته الأصلية، بشكل يجعله يتلاءم وسياقه الحضاري والثقافي الجديد، لدرجة تكاد تعادل، أو تفوق، قيمته الأدبية الأصلية، نظراً لاختلاف بلاغات اللغات والحضارات من ناحية، وتباين القراءات في علاقاتها بمؤهلات المترجمين وقدراتهم الإبداعية من ناحية أخرى. نقول هذا لأن الشائع في عالم الترجمة الأدبية عموماً في العالم العربي أن هناك متطاولين على المجال المختص، ممن وصفتهم مرّة الدكتورة هدي مقتص بحق في إحدى حوارتها بـ”المترجمين الزائفين”، وما أكثرهم للأسف الشديد في وقتنا الحاضر .
وتتشكل قناعة في أهمية الترجمة الأدبية ودورها الخلاّق إذ يقال “إذا كان النص يدين بوجوده الأول إلى مؤلفه، فإنه يدين بديمومته إلى مترجمه، ذلك أن الترجمة تمنح النص حياة أطول، وقابلية أكبر على البقاء والاستمرار .ولننطلق في رحلة ممتعة مع مقطتفات من راوية “ها هو اليتيم في عين الله”، يقول الراوي :”اضطربت مكة هائجةً.. مائجةً بعد أن حمل إليها ذاك الفارس المرهق الأشعث بشائر القدوم، فأعدّت النساء الدور بكل جلبة وسرور، وغسّلن الصغار في سرعة وعجل، وألبسنهم ناصع الحلل، ثمّ اتخذن لأنفسهن زينة فاخر الثياب وعجلّن في الذهاب إلى الفراش، ثمّ استيقظن والفجر مسرعات.. راكبات أو راجلات، يحملن بين أيديهن الصغار، فتوجّهن بهم نحو ظاهر المدينة في لهفةٍ إلى لقاء الأخوة والأزواج، معهن جمع غفير من الرجال ممن جاء يستقبل عروضه التجارية، وهو يقدّر الأرباح ويحسب لها الحسبان” .
في هذا المقطع يتضح الشغل الجمالي في صياغة الترجمة من اللغة الفارسية إلى العربية، فإذ به يسحبك إلى عالم لغوي مفارق تماماً للسياقات السردية الجمالية الأخرى التي نشهدها عادة في الرواية العربية تحديداً، في بنية الكلمة ودلالتها، في تركيبها الجمالي المتسق في شرح يستفيض منه البعد الإنساني في أرق صوره، في هذه الحال لا يعود نص هذه الرواية المترجمة نسخة تحجب النص الأصلي، وتقوم مقامه، بقدر ما ستصبح فعل خلق جديد، يعيد إبداع النص المترجم، وفاق شروط لغوية من ألسنية العرب الجميلة والقادرة على إكسابه أبعادا دلالية وجمالية أخرى، أكبر وأوسع، لم يكن ليحلم بها في لغته وسياقه الأصليين.
مع هذه الرواية تضاف إلى مهمة الترجمة الأدبيّة، والتي منها تبادل المعارف، وتقليص هوية الاختلاف بين الشعوب والحضارات، مهمة جديدة وهي كما وصفها الكاتب الألماني يوهان جوته بحق “أداة لبناء الكونية”، وهذا يقود إلى الحديث عن حسن اختيار النصوص المعدّة للترجمة والتي تتصف بجدارتها لتصبح كونية. هذا شرط أول وشرط ثانٍ أن يكون المترجم نفسه يتجاوز مسألة مجرد امتلاك لغتين أو أكثر، تمكّنه من النقل الحرفي (الأمين) لمحتوى العمل الأدبي بل أن يمتلك الحس الفني والذوق الرفيع وعشق الأدب وحب الكتابة، الذي لا بد من أن ينعكس بصورة ما في النص المترجم . وهذا ما لاحظناه بقوّة في عمل المترجمة الأستاذة “بتول مشكين فام” في ترجمتها هذه الرواية المبدعة. وربما لهذا السبب تشترط بعض دور النشر العالمية على من يريد العمل لديها في هذا القطاع أن يكون قد مارس كتابة الأدب من قبل، أو لا يزال يمارسها. من هذه الناحية، يرى بعض النّقاد العاملين في الحقل الأدبي دور المترجم يكاد يعادل دور المؤلف، إن لم يكن أكثر، لأن إعادة خلق نص موجود في لغة أخرى أصعب بكثير من كتابة نص جديد . على الأقل بالنظر إلى حجم الحرية المتاحة لكل منهما. تماما كما لاحظ مصطفى العقاد بحق عندما قال :”المنشئ مطلق في تفكيره وتعبيره، أما المترجم فله قيود من كلام المنشئ الأصلي، ولولا قدرة عنده على التصرف بالمعاني والكلمات لما استطاع التوفيق بين كلامه وفكر غيره في هذه القيود” .
ويقول الراوي كما تنقل المترجمة متصرّفة في الكلمات والمعاني :” في صبيحة اليوم الخامس من الحيرة، حرنت أكبر الإبل سنّاً، وجُنّت الأُخر جنونها من شدة الظمأ والسغب، فجمجمت نافرة تأبى الإنقياد. وفي اليوم السادس، لما جزعت الإبل وضاقت عليها الأرض بما رحبت، لم نر بدّاً من إطلاق سراحها، تركناها وأذعنّا لوعثاء الطريق نترنّح فيها مرهقين منهكين” . لنلاحظ هذه المفردات “حرنت”، السغب، حمحمت نافرة، وعثاء الأرض..، يبدو هنا جلياً براعة المترجمة في الإضفاء على النص روح البلاغة العربية وأناقتها الجمالية في الألفاظ والمعاني. وهي بالمناسبة لم توضّح في الهامش غير كلمة “حرنت”..!. وهي عبارات وألفاظ نفتقدها منذ زمن طويل في الرواية العربية نفسها. فهل يصحّ هنا أن نتفق مع الفيلسوف التفكيكي “جاك دريدا” الذي اقترح استبدال مصطلح الترجمة بمطصلح التحويل..؟!.
أعتقد أن تلاقي الأدبين العربي والفارسي، في صيرورة عملية الترجمة يفترض أن يبدأ من هذا المستوى االذي تقدّمه الأستاذة “بتول مشكين فام”، والتي ستدخل ضمن ما يصفه المنظّرون المعاصرون للترجمة بـ”الإبداع الخلاّق”، وما شابهها نظراً لما تقدّمه من إضافات مشرقة ومضيئة للنصوص المترجمة، غالباً ما لا تخطر على بال كتّابها الأوائل، مما يشكل جوهر الدينامية الدائمة والمستمرة التي يعرفها الاشتغال في هذا المجال.
بقي أن نقول إنّ هذه الرواية تعدّ الأولى في إيران من نوعها التاريخي كونها تنحبك حول قصة النبي محمد (ص)، واعتقد أنها كذلك في العالم العربي بلحاظ محاولات حاولت الاقتراب من هذه السيرة. وهي تحتاج من القارئ العربي إلى الاستعانة بقاموس للألفاظ والمعاني كونها التزمت بثقافة ذلك العصر التاريخي ومفرداته اللفظية.
المصدر: موقع المنار