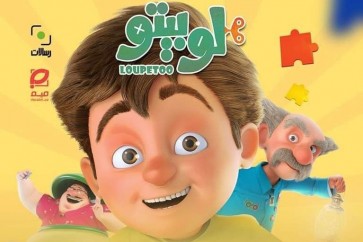تستحوذ عليك هذه الرواية الإيرانيّة حين تمسك بها، تدخلك إلى عالم يعود بك سنوات بعيدة قبل قيام الثورة الإسلاميّة، حين كان ممنوعاً على المرأة أن تخرج بخمارها وحجابها الكامل وحين كان السُّفور يُفرض على مجتمع مسلم تقليديّ في تمسّكه بالدين وتعاليمه. الرواية هي رحلة تاريخيّة، يسبح فيها الزمن متكسّراً على أهداب حبّ لم يرَ النور، بقي منتظراً خمسين عاماً حتّى قرّر لحظة البداية، فإذا بها نهاية مأساويّة جلبت معها نوراً آخر، حين أشرقت روح الثورة فهل تُخلق الحياة من الموت؟!
* تبدأ الرواية بوصف الزمان وتحديده
يأخذنا الراوي في رحلة تاريخيّة تعود إلى العام 1933م. ويزخر وصفه المكانَ بتلك الرصع اللغويّة، التي لا تنفكّ تسحبك إلى تلك الحقبة التاريخيّة من شوارع طهران. ثم تنقلك الأحداث ومن خلال حبكة قصصيّة أخّاذة إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تصبح مقرّ أبطال الرواية، في المقهى الفرنسي حيث يتواجد “علي” و”مريم” و”مهتاب”. كانت باريس في تلك الحقبة ملاذاً للإسلاميين؛ هرباً من بطش الشاه. فها هي مريم الفنانة التشكيليّة، التي تذرّع جدّها الحاج “فتّاح” بإرسالها إلى باريس لمتابعة الدراسة في حين كانت غايته أن تحافظ مريم على حجابها الإسلاميّ الكامل، بعدما هجم عليها الشرطيّ “عزّتي” وخلع عنها خمارها في منتصف الشارع وهي خارجة من مدرستها، فبقيت حبيسة بيتها سنواتٍ عديدة.
* الزمن المتنقّل في الرواية
ينفتح السرد في الرواية على أزمنة مختلفة، تتداخل بين ماضٍ قريب وآخر بعيد، وبين حاضر قريب، وآخر يكاد يكون رؤية للمستقبل، فنجد أنفسنا أمام لواحق سرديّة، وهو ما يوقعنا في “مفارقات زمنيّة” يُقصد بها مختلف أشكال التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية. ولا يلغي هذا التلاعب بالزمن ميزة النص في شبهه لأسلوب القصّ الواقعيّ.
* الدرويش مصطفى والقسّ الفرنسيّ
يعود السرد ليتابع مسار شخصيتَيْ “علي” و”كريم”، وكلاهما يحمل الوجه الأوّل ونقيضه بين الإيمان الدينيّ والتفلّت من عقاله، في خضمّ أجواء منفصمة في مجتمع متمسّك بكلّ تلابيب الدين وبين سلطة تراوح في الاندماج بركب الحضارة الغربيّة آنذاك، حين كانت الدعوة إلى الوجودية وإنكار وجود الله في تصاعد كبير. “كريم” الذي حاول تجريب الصلاة في خضمّ سُكره قبل قتله بأيّام، كان الوجه الآخر لـ”علي” وصراعه بين انتماء حمله لتعاليم الدرويش مصطفى وبين قسّ فرنسيّ، كان كلّ ما فيه يذكّره بالدرويش مصطفى، وكأنّه يختزل المسافة الزمنيّة من خمسينيّات القرن العشرين في إيران إلى أوّل الثمانينيات في باريس، “كنت أرى من خلال النافذة الصغيرة عباءته ومعطفه الأبيض، كان وجهه وجه الدرويش مصطفى، لكنّه قصّر لحيته وشعره، بعد حين انتبهت أنّ صوت القسّ هو نفس صوت الدرويش مصطفى هادئ ورنّان، أدخل يده من النافذة، رأيت خاتم العقيق وقد تمّ نحت عبارة على إطار الخاتم “محمد اللهم صلّ على محمد وآل محمد”(2).
* “عليّ” بين باريس وطهران
هاتان الصورتان، وجها الدرويش مصطفى الإيرانيّ والقسّ الفرنسيّ، شكّلتا هويّة زمنيّة فاعلة بالنسبة إلى شخصيّة “علي”، أعادت إليه توازنه إلى حدّ أبقاه مسيطراً على مجرى حياته، التي كانت تسيّرها ظروف بلاده القاهرة. فبعدما تخلّص من حكم الشاه الديكتاتوري شُنّت عليه حرب لا هويّة محدّدة لها إلّا قتل نوع الحياة الذي اختاره الشعب الإيرانيّ. فكيف حدث أن تاه “علي” بين شوارع باريس وبرجها العاجيّ، وهو يتخيّل نفسه في شارع حارته في طهران؟! البرودة وحدها أعادته إلى الواقع، حين لمس ذلك العمود الملتصق ببرج الإليزيه، فاقشعر جسمه وانتفض لذكريات طفولته وصباه، كيف أنّ برودة باريس هذه لا تشبه ألفة شوارع عاصمته!
غير أنّ هذه البرودة كانت تتشابه مع شوارع طهران وناسها خلال حكم الشاه؛ إذ كان حبّه لـ”مهتاب” يراوح مكانه، كانت جدران بيته الملاصق لبيتها فيها شيء من الجليد، يمنعه من حرارة الإقبال باتخاذ قرار الزواج ولم يستطع تجاوز رأي والدته في أنّ “مهتاب” تنتمي إلى وسط اجتماعيّ أقلّ قيمة من مكانة عائلته.
* مراوغة الزمان
وحده “الدرويش مصطفى” جعله يقف على طرفَي نقيض باتّجاه اتّخاذ القرار، حين لفت نظره إلى أنّ المكان يخضع لترتيب الزمان وثقافته: “كيف يمكنني أن أتزوّجها؟ إنّها في الجهة الأخرى من العالم”، يقول له “الدرويش مصطفى”: “لا وجود لجهة أخرى من العالم، مشارق الأرض قريبة من مغاربها. إنّ وصولك إلى مهتاب يحتاج إلى الزمان وليس إلى المكان، إنّها مسألة وقت فحسب”. وفعلاً استغرق “عليّ” ما يقارب ثلاثين سنة حتّى اتّخذ قراره بالزواج من “مهتاب”، والتي بقيت بانتظار هذا القرار، ولكنّ الزمن أيضاً يُخضع المكان مجدّداً إلى مرواغته حين اشتعلت حرب نظام صدام على ايران وقضت “مهتاب” وأخته “مريم”، بفعل صاروخ غادِر استهدف البيت، كانتا قد عادتا لتوّهما من باريس. وفقد “علي” بموتها قيمة الزمان، وظلّ المكان الذي يمثّل القيم بالنسبة إليه هو الأعلى وجوداً.
* “يا علي مدد”
عندما يموت “علي” في ختام الرواية، وحين يُشكّ في ما إذا كان قد فارق الحياة فعلاً، ويُقرّر نبش القبر لاستخراج الجثة، يأتي الدرويش مصطفى، وهو يردّد “يا علي مدد”، ويقول لـ”هاني”: “لم يحدث شيء خارق يا هاني، لقد رحل في الوقت المناسب من دون أيّ متاعب يسبّبها لأحد”. بقي الزمن هو الماثل القائم في تحكيم الحدث وصيرورته في الرواية، وهي فلسفة تقضي بالقول إنّ الزمن الثقافيّ أرفع منزلة من الطبيعة، وهو يحمل في ثوانيه ودقائقه تشظّياً لطالما عاشه “عليّ” حتّى عندما كان في كنف جدّه “عبد الفتاح”، زمن ظلّ العباءة التي يرخي عليها “عليّ” كلّ إخفاقاته. وعندما كاد ينجح في فرنسا، أعادته طهران إليه على صهوة زمن مليء بعنف الحرب، فغادر الدنيا في زمن فعليّ روحيّ قبل أن يغادرها جسديّاً، وبقيت كلمات “يا علي مدد” التي يردّدها على مسامعه “الدرويش مصطفى” هي المفتاح الذي لم يعرف “علي” أن يكشف سرّه أو حتّى أن يؤمن به.
وبذلك يمثّل “عليّ” الشخصية المنفصمة التي حاول زمن الشاه خلقها وهو يلحق بالزمن الأميركيّ، فتى صغير يفقد والده بعدما تقتله حكومة الشاه، يربّيه جده الأرُستقراطيّ “المؤمن” وسط الدراويش. غير أنّ الزمن الفرنسي أثار تشكيلاً أكثر تعقيداً في شخصيّته المتبرّمة دوماً، فكان التشظّي درباً وعراً لم تجد معه روحه السكون أو الهدوء أو حتّى القدرة على اتّخاذ القرارات المصيريّة في حياته.
المصدر: مجلة بقية الله