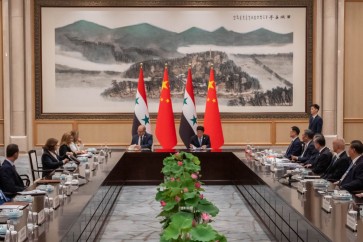يعتري مسار الحياة وقفات، وتكون هذه الوقفات عاملاً مهمّاً بما تحمله من مؤشّرات أسست لها عبر سنوات حقبة تاريخيّة شهدت تطوّراً على مستوى الصّراع مع الكيان الصهيوني، ذلك أنَّ هذه المؤشرات تكون مساعدة في سبر الصورة المستقبليّة المحتملة.
وبناءً على ما سلف، ليسَ غريباً أو روتينياً أن يكون للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، يوماً للشهيد، الذي ترك فيه الشهيد أحمد قصير مفاتيح العصر الاستشهادي الجديد الذي يتفق وينسجم مع منهج المقاومة ككل وكجسدٍ واحد في نحت ملامح نمط المواجهة مع العدو، والتأسيس من خلال ذلك إلى سبك مرحلة تُغيّر النمط، وتُخلخِل ركائز العدو في توظيف فوائض القوة على جبهاتٍ عدّة، وتتعاطى مع كلّ مرحلةٍ بحسب مستلزماتها على قاعدة رفض تشريع الاحتلال واستمرار المقاومة كأصل.
ما تجدر الإشارة إليه، أننا هنا لا نخصص عملية بحد ذاتها؛ كونها ليست الأوحد وإن كانت الأهم، ولكنها تشكّل محطة الانطلاق على مستوى الوعي الجمعيّ المقاوم في لبنان التي مرّ طريقها من فلسطين، وكان لتغذيتها الرّاجعة انعكاساً على نوعيّة العمليات داخل فلسطين المحتلّة، عندما أدركت خطورة الاحتلال، وتيقّنت من حتمية محاربته، حتى وصلت إلى ضعضعة قوائم استراتيجيات تعامله منذ التحرير 25/ مايو 2000، بعد سعيه من خلال عدوانه على تحقيق المدى الأمني له.
تتأتى أهمية مراجعة العمليات، وهي غير منسية بطبيعة الحال، من تبدّل عوامل ومناخ توظيف العدو لقوّته، في ظلّ الاتجاه لكيّ الوعيّ العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص، من خلال محاولات النفاذ المستمرّة لعقول الأجيال، عبر خلق المساحات التي توفّر البيئة المواتية لتلبية الرّغبات الشّابة أو ما يسمّى (الطبقة الرخوة) ما يعني بالنتيجة انصراف عن الهمّ الأكبر، نحو التشبّع الغريزي، ويتمظهر الأمر المذكور، إما بشكل مباشر في ساح المواجهة، مثل ما يحصل داخل فلسطين المحتلة من محاولات نشر ثقافة تعاطي المخدِّرات، وضرب المحتوى المناهض لسياسات الاحتلال، أو عبر تبعات الحروب المدعومة بطريقة أو بأخرى من “إسرائيل” وحلفاؤها في المنطقة، عبر التجويع، الحصار، بذر ثقافة التحريض، وسحق مفاهيم ضرورة مواجهة العدو، وتنميط طريقة التعاطي مع الأخطار المحدقة المُستهدِفة للبنى الفوقية، أي التأثير بأي شكل على “الجيل الجديد” الذي يراد فيه أن يكون وفق المنظور “الإسرائيلي” بارد الهام، لين الإرادة، باهت العزيمة.
عمِلَت “إسرائيل” منذ ما بعد الانتفاضة الثانية على جعل الاقتصاد الفلسطيني قائماً على الهِبات الخارجية، ما أمّن لها الهدوء النسبي، ولكن ما لبث الأمر لئن برز الجيل الذي تخشاه، في انتفاضة السكاكين 2015، المراكمة للوعي المقاوم المؤسس لما تشهده الساحات الفلسطينية اليوم، حيث يشكّل الشباب الفتيّ عمودها الفقري، كما شكّل فاتح عصر الاستشهاديين القَصير ذو الـ19 ربيعاً شيفرتها أيضاً.
وكحال الثائر لدم عدي التميمي ذو الـ19 همّة، بعد أن حوّلَ المطارِد لمُطارَد، نجحَ الشباب الفلسطيني في تحويل تهديد “الانترنت” لفرصة سهاد تحرق أجفان الأعداء، حيث تعتمد سرايا القدس والمجموعات المُقاوِمة، على العمليات المصوّرة التي توثّق أعمالهم وتقطع الطريق أمام أي روايات مضللة يسوق لها الاحتلال ضد المقاومة. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن “كتيبة جنين” وهذه المجموعات المتنامية تمثّل الجيل الشاب من “المقاومة العسكرية الحديثة” التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة “تيك توك” من خلال توثيق إطلاق النار ضد جنود الجيش ويتأكدون من نشر مقاطع الفيديو وإرفاقها بتفاصيل الأحداث والتواريخ. وأضافت الصحيفة أن “كتيبة جنين” غذّت ظاهرة المقاومة المسلّحة في الضفة الغربية منذ عام ونصف، وأعطت زخماً لظهور مجموعات مسلحة في مدن أخرى منها، منها نابلس وطولكرم وطوباس، الأمر الذي دفع بالاحتلال لزيادة الضغط على الضفة الغربية وتكثيف تواجده على مفارق المناطق المعزولة ومحاولة قطع تواصلها مع المناطق الأخرى، ما يعني إشغال العدو على أكثر من جبهة، وإيصال رسالة عنوانها: غزّة ليست الوحيدة.
تبرز أهمية العمل المقاوم من ناحية أنّه لم يربط النّاس به كمحور بمعزل عن المنهج، ونجاحه في أن يكون الإطار الفاعل في تحشيد الطاقات، وتوزيع الأدوار، وإنجاز التجربة العملية في ساحة الجهاد.
ولا يفوتنا أن ننوه، إلى أن ارتكاز القاعدة الأساس في مواجهة الخطر الصهيوني الحالي والمستقبلي تنبثق من الثقافة المتولّدة من طبيعة وضرورات الصّراع، فالفعل يعكس فِكراً، والفكر مُجَسَّد في الفعل، لذا يمكننا القول، بالرغم من كلّ الأخطار الدّاهمة المحاولة لإفساد أفنن النضال، إنَّ ثقافة المقاومة، ووفق ما هو معروف علميّاً أن الثقافات مكتسبة وليست وراثية، غدت موروثة لكل من تربّى وحمل في وعيهِ الحرّية ورفض الذل والتبعية وابتلاع الحقوق، وتشكّل المدافع الحقيقي والمواجه الأوّل للعدو وحلفائه.
ومصدرها هو اعتبار الصراع مع العدو صراع وجود لا صراع حدود، وفق ما تسرده سطور التاريخ في الصراع معه خلال 50 عاماً وتزيد، عدا من تمايّز صفّه وخرج من دائرة الصراع مع الاحتلال ووقع في شباكه، وثقافة المقاومة وبما لا يقبل مجالاً للشك هي التي شكلت حاضن الانتصارات المغيّرة لزخم السياسات العدوانية عملياً، وأضحت حالةً قائمةً ومنظومةً لا لضرورة مرحليّة، بل إرث تاريخيّ، ولو كانت مرحليّة لتأثرت بعوامل مراحل الصّراع المتطورة وجثت على ركابها، إلا أنها تزايدت توهّجاً وتعددت أساليبها، مستغلّة عوامل الضعف تارةً والقوة تارةً أخرى وسخّرتها لصالحها، فهي ثقافة جامعة لأي ثقافة تواجه العدو وفي مقدمتها المقاومة بالسلاح.
يفرض استكمالها علينا الاستمرار في مواجهة كل ما يهددنا ويهدد تطلعنا نحو التحرير والتحرر، فهذه الثقافة اليوم هي التي يعمل العدو على ضربها وتشويهها والأمثلة كثيرة لضرب النسيج التعبوي والثقافي المُعدُّ للمواجهة والقتال. منها، حظر محتوى كل ما يتعلق فيها، واغتيال العقول التي تملك عوامل فناء العدوّ، وسيناريوهات الإقناع لتحويل الصراع إلى جذوة من رماد تتطاير مع أول هبّة ريح وتذري الغبار في العيون لتعمينا عن الحق والحقيقة، ومنظومة هذه الثقافة تحتّم تطوير وترسيخ كل ما خلقته، فالشهادة هي عنوان هذه الثقافة، وحشد الرأي والكلمة الرافضة لكل ما هو عدو والمتبنّية لكل ما هو مقاوم أحد مقوّمات هذه الثقافة التي ولّدها وعي الشعوب وإدراكها لخطورة ما يُحدق بها، وتفرض علينا الكثير من الالتزامات الرامية لإبقاء جذوة المقاومة مُتقدة وحامية تحرق كل توجّه يفكر في إخمادها.
المصدر: موقع المنار